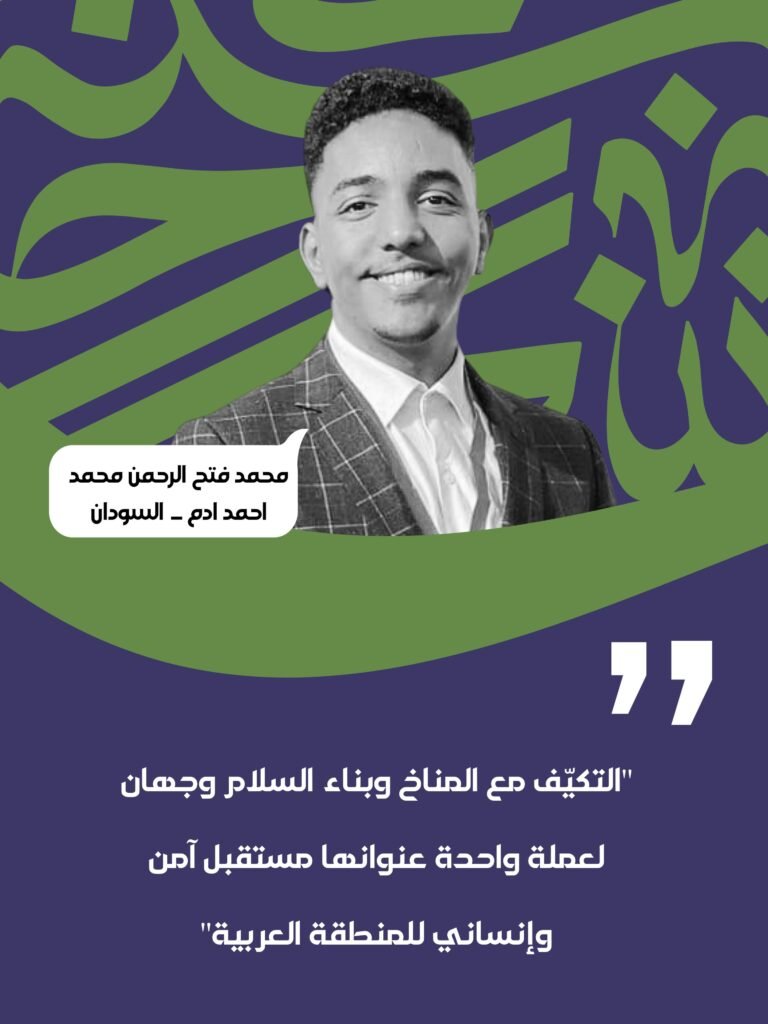مقدمة:
في سهول الشام الجافة، خرج فلاحٌ من قريته يحمل ما استطاع من متاعٍ، متجهًا نحو مدينة قريبة بعد أن جفّت بئر الماء التي اعتمدت عليها أسرته لأجيال. وعلى مشارف تلك المدينة، يصطدم بزحام مخيمات النازحين الذين دفعتهم الحرب إلى نفس الملاذ. هذا المشهد التخيّلي يلخّص التقاء التحديات الريفيّة والحضريّة في ظلّ تغيّر المناخ والنزاعات في عالمنا العربي. إذ لم يعُد بالإمكان النظر إلى تأثيرات المناخ على الأرياف والمدن بمعزل عن بعضها البعض، فالجفاف الذي يضرب القرى يرسل موجاته البشرية إلى المدن، والفيضانات التي تعصف بالمدن تمتد تداعياتها إلى محاصيل الريف وأسواقه. يضاف إلى ذلك بُعدٌ أشدّ قسوة: الصراعات والنزاعات المسلّحة التي تضعف قدرة المجتمعات على التكيف وتحرمها مواردها الأساسية. في هذا المقال سنتناول الترابط الوثيق بين تحديات المناخ في الريف والحضر، وكيف تؤدي النزاعات إلى تفاقم هذه التحديات، مع أمثلة من اليمن والسودان وسوريا، لنخلص إلى رؤية شاملة للتكيّف والسلام في آن واحد.
حلقة الوصل بين الريف والحضر: هجرة مناخية وتبادل هشاشة
لطالما كانت المدن والقرى في بلادنا في حالة تبادل وتفاعل؛ يهاجر الناس من الريف إلى المدينة بحثًا عن فرص، وتتمدّد المدن لتلتهم الريف في أطرافها. لكن تغير المناخ أدخل عاملًا جديدًا يسرّع وتيرة هذا التبادل ويجعلُه أكثر إيلامًا. فمع اشتداد موجات الجفاف وتصحر الأراضي الزراعية، وجد كثيرٌ من فلاحي الأرياف أنفسهم مجبرين على ترك قراهم والتوجّه نحو المدن بحثًا عن سبل جديدة للرزق. حدث ذلك بصورة جليّة في سوريا قبل اندلاع النزاع هناك، حيث شهدت البلاد بين ٢٠٠٦م و٢٠١٠م موجة جفاف قاسية عُدّت من الأسوأ خلال قرن. وقد أدّت هذه الكارثة إلى نزوح ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف شخص من المزارعين وأسرهم من المناطق الزراعية المتضررة نحو مراكز حضرية بحثًا عن عمل وماء. فجأة، وجدت المدن السورية نفسها أمام أحياء عشوائية جديدة مكتظة بأُناس فقدوا موارد رزقهم، مما زاد الضغط على بنيتها التحتيّة الضعيفة أصلاً. هذا المثال السوري ليس معزولاً؛ فاليوم مع ازدياد التصحر في العراق وشمال إفريقيا مثلاً، تتسارع الهجرة الداخلية نحو المدن، ويبرز مصطلح “الهجرة المناخية” كواقع تعيشه مناطق كسهل نهر الفرات أو بوادي المغرب.
لكن الهجرة المناخية نحو المدن تخلق حلقة معيبة: فازدحام المدن بالسكان الوافدين يُربك خدماتها ويزيد استهلاك المياه والكهرباء، ما قد يؤدي بدوره إلى مفاقمة الأزمات خلال موجات الحر أو الفيضانات الحضرية. وفي المقابل، إفراغ الريف من سكانه يُضعف الإنتاج الزراعي المحلي ويجعل الأمن الغذائي للمدن أكثر هشاشة واعتمادًا على الواردات. ففي السودان مثلًا، تسبّبت موجات جفاف في ثمانينيات القرن الماضي في نزوح آلاف الأُسر من مناطق دارفور وكردفان نحو العاصمة ومدن أخرى.
هذا النزوح، مع عوامل أخرى، ترك مساحات شاسعة من الأراضي دون حراثة أو رعي، فتدهورت التربة أكثر وقلّ الإنتاج الزراعي، مما انعكس في النهاية على ارتفاع أسعار الغذاء في المدن. اليوم، يستمر هذا النزيف الديموغرافي من الريف إلى الحضر في السودان على خلفية مزيج من تغيّر المطر وتصاعد النزاعات، مؤدّيًا إلى أن ٥٩٪ من الأسر الريفية أصبحت تعاني انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوته2. وهكذا نجد أن معاناة الريف تضرب صميم حياة المدن، والعكس صحيح.
إن الترابط بين تحديات الريف والحضر يعني أيضًا أن الحلول يجب أن تكون متكاملة. فبقدر ما تحتاج المدن إلى استثمارات في البنية التحتية المقاومة للمناخ، يحتاج الريف إلى دعم لبناء قدرته على الصمود حتى لا يضطر سكانه للنزوح. فعندما نقوم مثلًا بإنشاء سدود لحماية مدينة من الفيضانات علينا أن نتأكد أنها لا تحرم المزارعين في أعلى النهر من مياه الري. وعندما نخطط لشبكات الأمان الاجتماعي في المدن لتغطي الفقراء، ينبغي شمول المزارعين الذين خسروا مواسمهم بسبب الجفاف. هذا التكامل في الرؤية بدأت تتبناه منظمات دولية عبر برامج تنمية شاملة تربط الريف بالمدن. في اليمن – البلد الذي يواجه مجاعة وجفافًا في آن واحد – ظهرت مبادرات لدعم الزراعة في المناطق الآمنة نسبيًا كي تزوّد المدن بالمنتجات وتوفر فرص عمل محلية، بينما في المدن يتم إنشاء أسواق خاصة لتلك المنتجات بأسعار عادلة تسهم في بقاء الفلاحين على أرضهم.
النزاعات المسلحة وتغيّر المناخ: تأثير متبادل وتصاعد خطير
في خضمّ الحديث عن التكيّف والتنمية، تقف النزاعات المسلحة كعقبة تقوّض كل الجهود. فحين تشتعل الحروب، تصبح أولويات البقاء الآنيّة متغلّبة على أي تخطيط مستقبلي، ويغدو تأمين لقمة العيش أهم من التفكير في تغيّر المناخ على المدى البعيد. لكن المعضلة أن تغير المناخ والنزاعات يدخلان في حلقة تغذية متبادلة تُفاقم كلاً منهما الآخر. فالموارد الطبيعية الشحيحة التي يقلّلها تغيّر المناخ (كالماء والأرض الزراعية) تتحوّل إلى محركات للنزاع. وفي المقابل، يدمّر النزاع ما تبقّى من قدرة على الإدارة المستدامة للموارد أو التعامل مع الكوارث الطبيعية.
اليمن يقدم مثالًا مأساويًا على هذا التشابك. فعلى مدى سنوات الحرب الأخيرة، عانى اليمنيون من انهيار منظومات إدارة المياه في مدن وقرى كثيرة نتيجة القصف وسوء الصيانة. وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة المياه المزمنة أصلًا، فاضطر السكان للاقتتال على ما تبقّى من آبار وينابيع. تشير التقديرات إلى أن الصراعات على المياه في اليمن تتسبب في آلاف الوفيات سنويًا نتيجة التوترات المحليّة. بل إن أطراف النزاع استخدمت المياه كسلاح؛ فتم توجيه الموارد إلى جماعات موالية وقطعها عن أخرى كوسيلة ضغط. في الوقت نفسه، يأتي تغيّر المناخ ليزيد الطين بلّة: فاليمن يتعرض لموجات جفاف قاسية أدت إلى تقلّص نصيب الفرد من المياه إلى أقل من ١٠٠ متر مكعب سنويًا في بعض المناطق (أدنى مستوى عالمي تقريبًا)، كما أنه شهد فيضانات مدمرة في السنوات الأخيرة اجتاحت المدن والأرياف على حد سواء. فعلى سبيل المثال، ضربت سيول عارمة محافظة مأرب عام ٢٠٢٠م ودمرت أراضي زراعية ومساكن للنازحين، مفاقمة أزمة إنسانية قائمة. يغذي تغيّر المناخ إذًا أسباب النزاع (شح الموارد)، ويجعل نتائج النزاع أكثر فتكًا بالمجتمع (بانهيار القدرة على التأقلم مع الكوارث).
وفي السودان، يُنظر إلى إقليم دارفور كنموذج لما سمّاه بعض المراقبين “أول نزاع بسبب تغير المناخ.” فدارفور عانت لعقود من تناقص المعدلات المطرية وازدياد فترات الجفاف، مما أجبر القبائل الرعوية والزراعية على التنافس الشديد على الأرض والماء. هذا الواقع المناخي الصعب شكّل خلفية للتوترات التي انفجرت في صراع دام ابتداءً من ٢٠٠٣م. وعلى الرغم من أن للنزاع أسبابًا سياسية وعرقية أيضًا، لا يمكن إنكار دور التغير البيئي في تأجيج. اليوم، يواجه السودان نزاعات جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ١٥ ابريل ٢٠٢٣م، ضاعفت معاناة البلاد التي تضربها أصلاً أزمات مناخية. فقد أدى القتال إلى شلّ الموسم الزراعي في مناطق واسعة؛ وتُقدّر منظمة الأغذية والزراعة أن إنتاج السودان في موسم ٢٠٢٣م –٢٠٢٤م انخفض بنسبة ٤٦٪ عن العام السابق2. نتيجة الحرب وما صاحبها من نزوح للمزارعين وشح في المدخلات الزراعية، إضافة إلى تذبذب الأمطار. هذا الانخفاض الحاد هددت بمجاعة طالت الملايين داخل المدن وخارجها. ووسط النزاع، انهارت البنية التحتية الأساسية؛ فمحطات المياه والكهرباء خرجت عن الخدمة في مناطق القتال، ما جعل أي ظاهرة طبيعية – كعاصفة مطرية قوية في الخرطوم – تتحول بسهولة إلى كارثة إنسانية بسبب غياب آليات الاستجابة والصيانة.
أما سوريا، فهي مثال على كيف يُضعف النزاع قدرة المجتمع على التكيف المناخي. فبعد أكثر من عقد على الحرب، تدهورت نظم الري والسدود والخدمات الزراعية التي بُنيت عبر عقود طويلة. وعانى شمال شرق سوريا في عامي ٢٠٢١م و٢٠٢٢م من موجة جفاف حاد أدّت لانخفاض محصول القمح بشكل خطر، في وقت كانت البلاد بأمسّ الحاجة للغذاء. ولكن بسبب النزاع وانقسام السيطرة على المناطق، لم تكن هناك سلطة موحّدة لتعلن حالة طوارئ مناخية أو تنسق مساعدات للمزارعين أو تنفّذ مشاريع طارئة كحفر آبار عميقة. كما فاقمت الحرب مشكلة إزالة الغابات في سوريا، حيث تم قطع الأشجار بشكل جائر في بعض المناطق للتدفئة أو لبيع الحطب، مما جعل الأراضي أكثر تعرضًا للانجراف والتصحّر وفقدان التنوع الحيوي. هذا الضعف المؤسسي جعل سوريا من بين الدول الأدنى ترتيبًا في العالم من حيث الجاهزية للتكيف؛ فقد جاءت في مرتبة متأخرة جدًا (١٧٤ من ١٨٥) على مؤشر ND-GAIN العالمي لاستعداد الدول لمواجهة التغيّر المناخي . أي أن سوريا اليوم، بسبب الحرب، أقل قدرة بكثير على تحمّل الصدمات المناخية مما كانت عليه قبل ٢٠١١م، ما يعني أن أي كارثة طبيعية فيها تتضخم آثارها المدمّرة أضعافًا.
نحو تكيف شامل ومستدام: الحاجة إلى بناء السلام والمناخ معًا
تدلّ الأمثلة السابقة بوضوح على أن التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية المأزومة بالصراعات لا يمكن أن ينفصل عن بناء السلام وتعزيز الاستقرار. فبدون وقف النزاعات وتعزيز الحكم الرشيد، ستبقى كل الجهود التقنية والفنية للتكيف هشة وعرضة للانهيار. لقد بدأت المنظمات الدولية تدرك هذه الحقيقة. ففي اليمن مثلاً، دعت تقارير أممية حديثة إلى إدماج العمل المناخي في عملية بناء السلام، عبر الاستثمار في مشاريع إدارة مياه مشتركة بين المجتمعات المتصارعة كسبيل لتعزيز التعاون بينها. توصيات تقييم حول اليمن شددت على ضرورة أن تترافق جهود الوساطة والسلام مع دعم لاستراتيجيات التكيف والصمود، لأن السلام الدائم مستحيل إذا استمرت الصراعات على الموارد في ظل تدهور مناخي. وبالمثل، في السودان، يرى الخبراء أنه يجب تضمين محور خاص للتكيف المناخي في أي اتفاق سلام مستقبلي، يتضمن التزام كافة الأطراف بإعادة تأهيل البنى التحتية للمياه وتشجير المناطق المتصحرة ومنع الرعي الجائر وتنظيم استخدام الموارد بين القبائل .
على الجانب الآخر، فإن تعزيز القدرة على التكيف المناخي قد يساهم في منع اندلاع نزاعات جديدة. إذ حين يشعر الناس بالأمان المائي والغذائي في مناطقهم، تقل الدوافع للصدام مع الجيران أو للهجرة الاضطرارية. لذلك، فإن الاستثمار في التكيف هو استثمار في الاستقرار. تخيّلوا مثلاً لو لم يهمل العالم معالجة آثار جفاف سوريا ٢٠٠٦م و٢٠١٠م بشكل تنموي عادل؛ ربما كانت شريحة من المجتمع السوري أقل غضبًا ويأسًا مما وصلت إليه قبيل ٢٠١١م. كذلك الحال في جنوب العراق حيث أثار جفاف الأهوار وتملّح الأراضي نقمة اجتماعية يمكن أن تتحول إلى اضطراب أمني إذا لم تُعالج بجديّة عبر مشاريع استصلاح وتوفير بدائل للمزارعين والصيادين هناك.
إن نهج التكيف الشامل الذي يراعي ظروف النزاع يتطلب آليات مبتكرة. قد تشمل هذه الآليات ممرّات آمنة للمساعدات المناخية إلى مناطق النزاع، بحيث لا تُعرقل المعاركُ إيصالَ البذور المحسنة أو الدعم التقني للمزارعين المحتاجين. وقد تتطلب إنشاء صناديق دولية خاصة لدعم التكيف في الدول الهشّة والفاشلة، يكون الإنفاق منها سريعًا ومرنًا لتلبية الاحتياجات الفورية (كحفر آبار أو إصلاح سدود متضررة) وبنفس الوقت لبناء القدرة بعيدة المدى (كتدريب المجتمعات على أساليب زراعة جديدة أكثر تحملاً للجفاف). كما يمكن بناء منصّات تعاون إقليمية لتبادل المعرفة بين الدول الخارجة من نزاعات حول كيفية استعادة أنظمة إدارة الموارد الطبيعية. فدولة مثل لبنان رغم أزماته تمكنت من الحفاظ على قدر معقول من المؤسسات المعنيّة بالبيئة، ويمكن أن تشارك خبراتها مع سوريا المجاورة عندما تسمح الظروف.
خاتمة:
لا بد من التأكيد أن تحديات الريف والحضر في ظل المناخ المتغير مترابطة بشكل وثيق، وتتفاقم حدّتها في حضور النزاعات المسلحة. التجارب المريرة من اليمن والسودان وسوريا تظهر أن الفشل في معالجة هذه القضايا مجتمعةً قد يؤدي لكوارث إنسانية وتعميق دوامات العنف والفقر. وفي المقابل، يمثل العمل على بناء السلام والتكيف المناخي معًا فرصة مزدوجة لإنقاذ الأرواح وتحسين سبل العيش. إنه طريق طويل وشاق دون شك، لكن مع كل مشروع حصاد مياه في قرية يمنية، أو برنامج زرع أشجار في سهول السودان بالتوازي مع مفاوضات وقف إطلاق نار، هناك أمل بأن تنكسر هذه الحلقة المفرغة. عندها فقط، يمكن للريف أن يزدهر من جديد ويعود سكانه لديارهم مطمئنين، ويمكن للمدينة أن تتنفس الصعداء وهي تعلم أن ظهرها محمي بريف مستقر ومنتج. التكيف مع المناخ وبناء السلام وجهان لعملة واحدة عنوانها مستقبل آمن وإنساني للمنطقة العربية.
– محمد فتح الرحمن محمداحمد ادم
المراجع:
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Arab-States-CCA.pdf#:~:text=United%20Nations%20Development%20Programme%202018,drought%2C%20desertification%2C%20and%20changes%20in
https://carnegieendowment.org/sada/2024/06/climate-change-and-conflict-a-perfect-storm-in-sudans-countryside?lang=en#:~:text=thousands%20to%20relocate%20to%20urban,people%20fled%20the%20ensuing%20insecurity
https://gain-new.crc.nd.edu/ranking/vulnerability
https://mena.iom.int/sites/g/files/tmzbdl686/files/documents/2024-03/yemen-desk-review.pdf#:~:text=,GAIN%2C
https://explosiveweaponsmonitor.org/fragments/vol/1/issue/1/article/explosive-weapons-use-in-sudan/
https://www.wfpusa.org/articles/the-first-climate-change-conflict/#:~:text=Darfur%20has%20been%20labeled%20the,political%20factors%20leading%20to%20conflict
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1545156-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%94%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%A8
https://climate-diplomacy.org/magazine/conflict/undercurrents-how-conflict-climate-change-and-environment-intersect-yemen#:~:text=,thousands%20of%20deaths%20every%20year
https://www.icrc.org/ar/law-and-policy/climate-and-conflict
Environment, Conflict and Peacebuilding: Addressing the Root Causes of Conflict in Darfur
Environment, Conflict and Peacebuilding: Addressing the Root Causes of Conflict in Darfur